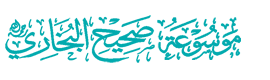-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░16▒▒ ( ╖ )‼ كذا ثبتت البسملة هنا في رواية كريمة، وسقطت لغيرها(1)، وهي ثابتة في «اليونينيَّة»(2) (كِتَابُ الكُسُوفِ)(3) هو بالكاف للشَّمس والقمر، أو بالخاء للقمر وبالكاف للشَّمس، خلافٌ يأتي قريبًا _إن شاء الله تعالى_ حيث عقد المؤلِّف له بابًا، والكسوف هو: التَّغيُّر إلى السَّواد، ومنه كسف وجهه إذا تغيَّر، والخسوف بالخاء المعجمة: النُّقصان، قاله الأصمعيُّ، والخَسف أيضًا: الذُّلُّ، والجمهور على أنَّهما يكونان لذهاب ضوء الشَّمس والقمر بالكُليَّة، وقيل: بالكاف في الابتداء، وبالخاء في الانتهاء، وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضَّوء، وبالخاء لبعضه، وقيل: بالخاء لذهاب كلِّ اللَّون، وبالكاف لتغيُّره، وزعم بعض(4) علماء الهيئة أنَّ كسوف الشَّمس لا حقيقةَ له، فإنَّها لا تتغيَّر في نفسها، وإنَّما القمر يحول بيننا وبينها، ونورُها باقٍ، وأمَّا كسوف القمر فحقيقةٌ، فإنَّ ضوءه من ضوء الشَّمس، وكسوفُه بحيلولة ظلِّ الأرض بين الشَّمس وبينه بنقطة التَّقاطع، فلا يبقى فيه ضوءٌ ألبتَّة، فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقةً. انتهى. وأبطله ابن العربيِّ بأنَّهم زعموا أنَّ الشَّمس أضعاف القمر، فكيف يحجب الأصغرُ الأكبرَ إذا قابله؟! وفي «أحكام الطَّبريِّ»: في الكسوف فوائدُ: ظهور التَّصرُّف في هذين الخَلْقين العظيمين، وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظُها، وليرى النَّاس أُنموذج(5) القيامة، وكونهما يُفعل بهما ذلك ثمَّ يُعادان، فيكون تنبيهًا على خوف المكر ورجاء العفو، والإعلام بأنَّه قد يُؤاخَذ(6) مَن لا ذنبَ له، فكيف من له ذنبٌ؟! وللمُستملي(7): ”أبواب الكسوف“ بدل: «كتاب الكسوف».
░1▒ (بابُ) مشروعية (الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) وهي(8) سنَّةٌ مؤكَّدةٌ لفعله صلعم وأمره كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والصَّارف / عن الوجوب ما سبق في «العيد»، وقول الشَّافعيِّ في «الأمِّ»: «لا يجوز تركها» حملوه على الكراهة لتأكُّدها ليوافق كلامه في مواضعَ أُخَر، والمكروه قد يُوصَف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطَّرفين، وصرَّح أبو عَوانة في «صحيحه» بوجوبها، وإليه ذهب بعض الحنفيَّة، واختاره صاحب «الأسرار».
[1] في (م): «وسقط لغيرها»، وفي (ص): «وسقط في غيرها».
[2] قوله: «وهي ثابتة في اليونينيَّة» سقط من (م).
[3] زيد في (د): «هل».
[4] «بعض»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[5] في (ب) و(س): «نموذج».
[6] في (ب) و(م): «يؤخذ».
[7] في (م): «للكُشْمِيهَنيّ»، وليس بصحيحٍ.
[8] في (ب): «وهو».